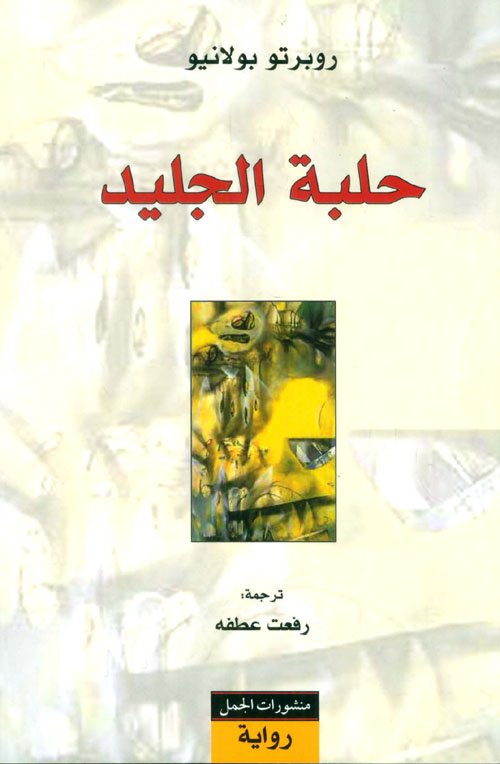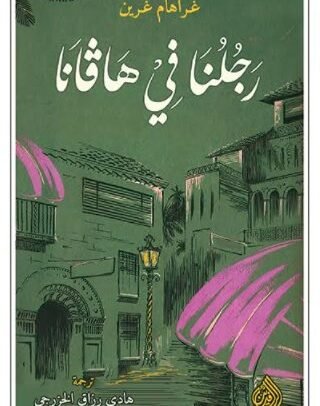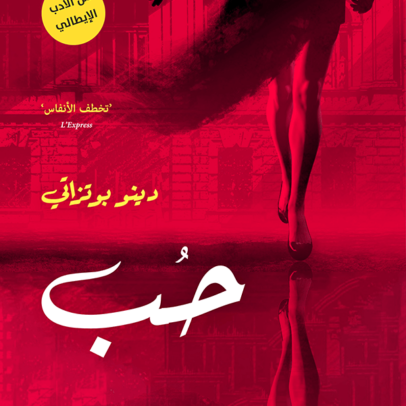د.ك2.5
حلبة الجليد روبرتو بولانيو
تك
“في تمام الساعة العاشرة صباحاً أخذت السيارة وخرجت في طريقي إلى قصر بنفينغوت. كان النهار ضبابياً ومنعطفات الطريق المحلي إلى “إي” معروفة بحوادثها. ولهذا قدت بمنتهى الحذر. كان السير قليلاً ولم أجد أية صعوبة بالعثور على القصر، المكان الذي أيقظ اهتمامي دائماً، سواء بسبب عمارته المحيّرة، كما بسبب أسطورة بانيه ومالكه الأول، جمال البيت، وإن كان خرباً، حافظ على نفسه مثل بيوت كثيرة في “كوستا برافا” و”مارِسمٍ” التي لا أحد يسكنها. كان بيت الحديقة الحديدي مفتوحاً، لكن ليس إلى الحدّ الذي يسمح بدخول السيارة. نزلت وفتحته على مصراعيه، صرّ الباب بشكل مريع. نكرت للحظة أن أتابع سيراً على قدميّ، لكنني ندمت بعدها وعدت إلى السيارة. كانت المسافة بين الباب الرئيسي والمنزل المشار إليه معتبرة كفاية وتمضي في طريق نصفه من الحصى ونصفه الآخر من التراب.. تركت السيارة مصفوفة بجانب رواق المدخل وقرعت الباب. لم يجبني أحد.. البيت خال.. قسم من البث مشاد فوق الصخور أو بالأحرى يغور في جرف صخري، في عناق غامض القصد، كان الباب المكوّن من درفتين مغطيتين بصاجٍ معدني مفتوحاً. دخلت. في الداخل، بنى أحدهم بإرادة طفل رهيبة سليلة من الممرات المربكة بارتفاع متر ونصف المتر. مستخدماً صناديق لا تحصى، كلما توغّل المرء فيه راح الارتفاع يتقلص إلى أن يصبح خمسين سنتيمتراً ونيفاً. كانت الممرات تمضي مشكّلة دوائر. في الوسط كانت حلبة الجليد. رأيت وسط الحلبة كتلة جاكنة متقوقعة، سوداء مثل بعض الدعائم التي كانت تعبر السقف المستوي لامعةً. كان الدم قد سال من الجسد المرمي على وجهه من عدد من النقاط وفي كل الاتجاهات، مشكّلاً رسوماً وصوراً هندسية ظننتها من النظرة الأولى ظلالاً، وصل مجرى الدم في بعض المناطق حتى حافّة الحلبة. تأملت، راكعاً على ركبتي.. كيف بدأ الجليد القاسي يمتص كامل دم المجزرة. اكتشفت في زاوية من زوايا الحلبة السكين.. بعدها بقليل اقتربت من الجثة بحذر شديد كيلا انزلق على الجليد وفي الوقت ذاته كيلا أدوس على الدم المتخثر. عرفت منذ اللحظة الأولى أنها كانت ميتة، لكن عن قرب كانت تبدو فقط نائمة، وعلامة انزعاج خفيفة تعلو طرفي عينيها الوحيدة التي كان باستطاعتي أن أراها، دون أن أبدّل وضعيتها. افترضت أنها كانت تلك العجوز التي ذهبت لتتكلم مع لولا، وبقيت برهة طويلة أنظر إليها وكأنني منوّم مغناطيسياً، وأنتظر، بلا عقلانية أن تظهر نوريا على مسرح الجريمة. بدت لي حلبة التزلج وقتها مكاناً مغنطسياً، رغم أن جميع سكانه وزوّاره تبخّروا منذ زمن طويل، وكنت الأخير في الدخول إلى المشهد. حين نهضت كانت ساقاي مجمّدتين. في الخارج كانت الغيوم تغطي كامل السماء وبدأت تهب من البحر ريحٌ متوعدة. أعرف أنه كان علي أن أعود أدراجي وأعلم الشرطة، لكنني لم أفعل. على العكس تنفسّت عميقاً عدّة مرات، قمت بقليل من التمارين، لأن ساقاي إضافة إلى أنهما كانتا مثلجتين، بدأتا تنملان، ومرة أخرى عدت، كما أن شيئاً يشدني بطريقة لا تقاوم، لأدخل العنبر، وتهت في الممرات الدائرية.. حتى الآن لا أعلم علم اليقين الدافع الذي دفعني لأن أفتش كامل البيت. وجدت في قاعة على شكل نعل فرس، في الطابق الأخير. تحت نافذة تطلّ على البحر، غاسبارين ملفوفاً ببطانية اسكتلندية ممزقة مع فتاة تبدو ظاهرياً نائمة. اعترف بعد أيام أنه عندما سمع خطواتي ظن أنها الشرطة ولم يكن أمامه من مهرب.. على كل الأحوال لم يفاجئني أن يكون غاسبارين قد اختار بالتحديد ذلك المكان كي ينتظر فيه ما كان يعتقد أنه وشيك. لم يقل أحدنا شيئاً للآخر، ونحن ننظر كل واحد إلى الآخر.. حين قررت أن أتكلم سألته عما إذا كان يعرف ما كان يوجد في الأسفل، في حلبة الجليد.. أجاب مؤكداً بحركة في رأسه، تصورته لثانية وهو يطعن العجوز بالسكين. لكن قلبي انتبه في الثانية التالية إلى أن ذلك محالاً. قلت له بعدها أن ينهض ويذهب. لا أستطيع أن أتركها. قال. اهرب معها. إلى أين؟ قلت: إلى المخيم وطلبت منه أن ينتظرني هناك.” رآه لأول مرة في شارع بوكارلي، في مكسيكو في المنطقة التي تنتمي لشعراء الحديد.. سمع صوته عميقاً.. الشيء الذي رآه عندما كان مراهقاً عاد ليظهر في حياته… لتدور الحكاية في معظمها حوله.. وصولاً إلى جريمة القتل التي دارت فيها الشبهات حوله.. إلا أن الأقدار شاءت أن يزج الراوي في هذه التهمة ليسجن ويعاني من وحشة السجن، ويبددها ببحث عنوانه “مشروع السجن الأوروبي” كان السبب من إطلاق سراحه.. وهكذا تمضي الأحداث.. من شارع بولكاري في مكسيكو إلى القاتل! سينكرون.. وتبقى الغاية من هذه الحكاية هي إقناعهم بعكس ذلك.