متوفر دفع اون لاين عبر الواتساب مرحبا بكم في موقع مكتبة الكويت ( المكتبة هي معبد المعرفة ومنارة الفكر بين رفوعها تتقاطع الافكار وتتلاقي العصور ) الحجز والاقتراحات واتساب 50300046 الشحن الي جميع المناطق ...
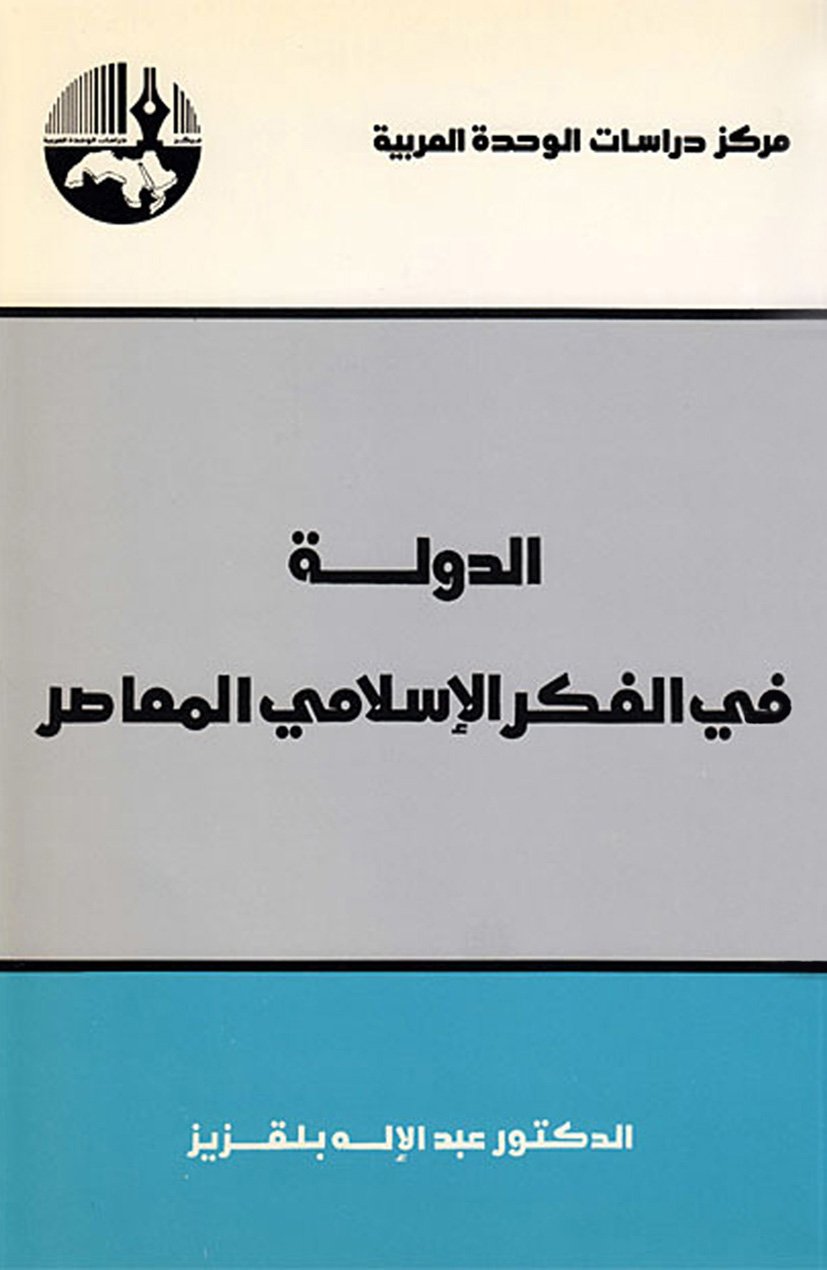
الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر
التصنيف : اسلاميات - فكر
دار النشر : مركز دراسات الوحدة العربية
عبد الإله بلقزيز
نشأت فكرة الدولة، في الفكر السياسي الحديث، في رحم فكرة الإصلاح وكانت من ثمراتها النظرية. لم تنطرح، في وعي الإصلاحيين، بوصفها مسألة فكرية مستقلة، بل حمل على التفكير فيها التفكير في مجمل الأسباب التي قادت المجتمعات العربية والإسلامية إلى حال من التأخر المزدوج. تأخر عن العصر، وتأخر عن الماضي المرجعي، مثلما حمل على التفكير فيها التفكير في جملة ما يمكن التوسل به لاكتساب أسباب الترقي والانتهاض، والانخراط الإيجابي في المدينة الحديثة. في كل حال، كانت الإصلاحية الإسلامية أول من صاغ مقالة في الدولة، وفي المسألة السياسية، منذ أقفلت موضوعات "السياسة الشرعية"، في العهد الإسلامي الوسيط، باب الحديث فيها، مكرسة معرفة وحيدة بالموضوع لدى أجيال متعاقبة من الفقهاء.
ضمن هذه المقاربة يأتي بحث الدكتور بلقزيز في هذا الكتاب. فهو يتناول تلك المسألة الرئيسة في حقل الفكر النظري والفكر السياسي وهي: علاقة الديني بالسياسي في وعي النخب الفكرية الإسلامية الحديثة والمعاصرة: كيف تمثلها هذا الوعي، وكيف عبر عنها خلال أزيد من قرن ونصف، وهي المسألة التي كثفتها نظرياً إشكالية الدولة في ذلك الوعي، والتي ستصبح، منذ تداعيات الغزوة الأوروبية لديار المسلمين في القرن التاسع عشر، نقطة انعقاد كافة القضايا والمعضلات المتصلة بمسائل الاجتماع السياسي والاجتماع الديني في مجتمعات العالمين العربي والإسلامي.
غطى البحث حقبة تزيد قليلاً على القرن والنصف، ممتدة منذ: تخليص الإبريز للطهطاوي إلى: السياسة الشرعية ليوسف القرضاوي (1998). وقد تصدت فيها أجيال خمسة من المفكرين الإسلاميين لبحث المسألة السياسية في الإسلام، ومسألة الدولة فيه على نحو خاص، وهي التي كانت نصوصها موضوع هذا البحث. أما الأجيال فهي: الجيل الإصلاحي الأول: جيل الطهطاوي، وابن أبي الضياف، وخير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده (وإن كان مخضرماً)، ثم الجيل الإصلاحي المتأخر: جيل الكواكبي ورشيد رضا، والنائيني. والجيل الثالث: جيل عبد الحميد بن باديس، وعلي عبد الرزاق، وحسن البنا، وأبي الأعلى المودودي، وأبي الحسن الندوي، وروح الله الخميني، وهو يمتد إلى علال الفاسي، ومحمد الغزالي، وحسن الهضيبي. والجيل الرابع، جيل سيد قطب، ومحمد قطب، والقرضاوي، والسباعي، ويمتد إلى عبد السلام ياسين. أما الجيل الخامس، فهو جيل فتحي يكن، وعبد السلام فرج، وراشد الغنوشي، وحسن الترابي (=مخضرم)، وفهمي هويدي، ومحمد عمارة... الخ.
وفي قراءة الدكتور بلقزيز لنصوص الفكر الإسلامي: الحديث والمعاصر، تمّ له الوقوف على أربع إشكاليات فكرية حول الدولة تداولتها الأجيال الخمسة تلك، وهي: إشكالية الدولة الوطنية لدى الإصلاحية الإسلامية بجيلها الأول والثاني، وإشكالية دولة الخلافة لدى رشيد رضا (وقد دافع عنها رجال "الأزهر" أيضاً في معركتهم ضد علي عبد الرزاق) ثم إشكالية الدولة الإسلامية مع حسن البنا والتيار "الإخواني": الحزبي والفكري؛ وأخيراً إشكالية الدولة الثيوقراطية مع المودودي، وقطب، والخميني. ثم التيار "الجهادي" التكفيري. إنها الإشكاليات التي أنتجت الخطابات الأربعة الرئيسية في التاريخ الحديث والمعاصر للفكر الإسلامي: الخطاب الإصلاحي، والخطاب السلفي الشرعي، والخطاب "الإخواني" ثم الخطاب الثيوقراطي: خطاب "الحاكمية"، و"ولاية الفقيه"، و"الجهاد" داخل "دار الإسلام"، ويقول الدكتور بلقزيز حول ماهية إشكالية الدولة لكل من هذه الأجيال، بأن كل جيل عاش إشكالية الدولة تلك على نحو خاص، وأنتج حولها خطاباً، غير أن ذلك ما عنى، البتة، انقطاعاً كاملاً بين تلك الإشكاليات والخطابات، بل كانت علائم من التواصل بينها قائمة، خاصة منذ ميلاد إشكالية الدولة الإسلامية والخطاب "الأخواني".
لكن الأهم أن الزمن المعرفي للإشكالية الواحدة منها لم يكن مطابقا، دائماً، لزمن الجيل الذي أسسها وتداولها، فإشكالية الدولة الوطنية لم تنته بغياب محمد عبده الكواكبي وانقلاب رشيد رضا عليها، بل تجددت مع علي عبد الرزاق، وخالد محمد خالد، وعلال الفاسي، ومحمد عمارة، ورضوان السيد... الخ، وإشكالية الدولة الإسلامية لم تنفرط بانفراط عقد جيلها الأول: جيل البنا وعبد القادر عودة، بل تجددت مع القرضاوي وعبد السلام ياسين، وفهمي هويدي ومحمد سليم العوا.. الخ غير أنه ظل،ّ في النهاية، تجدداً دفاعياً أمام زحف مقالات فكرية أخرى كان لها الفشو والغلبة، فضلاً عن أنه (تجدّد) ما، أضاف على الموضوعات التأسيسية جديداً فكرياً ينقلها إلى نصاب نظري أرقى، بل كان مبْلَغَ فعله أن أعاد ضخ الحياة فيها. وكان ذلك، بالضبط، ما حمل الدكتور بلقزيز في البحث على الذهاب إلى القول أن تاريخ الفكر الإسلامي الحديث تاريخ تراجعي أو نكوص.
من جانب آخر حاول الدكتور بلقزيز تناول الفكر الإسلامي الحديث في كليته، أي في تمظهُرية المذهبيّين الرئيسيين: السني والشيعي، ساعياً إلى تغطية حاجة معرفية ماسة إلى إفراد التراث الفكري والفقهي الشيعي الموقع الذي يستحق، في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث، بعد طول تجاهل من قبل الباحثين والكتاب المسلمين من غير الانتماء المذهبي الشيعي، ولم يكن حامله على ذلك أن الوقائع المعاصرة أثبتت حيوية الفكرة السياسية الشيعية في المجال الاجتماعي والسياسي فحسب، بل لإدراكه الحاد بأن أي تناول علمي للفكر الإسلامي سيظل ناقصاً ومبتوراً إن هو أقصى التراث الفكري الشيعي، بل لربما انتهى به أمره، من حيث لم يحتسب، إلى شكل ما، ولو غير واع، من أشكال الاغتصاب الطائفي والمذهبي والتخرب الايدولوجي-العقدي.
وأخيراً، وضمن منهجية اختطها الباحث فالنصوص تتكلم بغير قيد إلا ما اقتضاه الضابط المنهجي، فلم يُنِب عنها السارد إلا لحاجة استدعاها هذا المقتضى من البحث أو ذاك. وبمقدار حرصه على تقديم أكبر قدر من المادة الناطقة بذاتها، سعى إلى استنطاق خطابات نقدها من داخلها. هكذا انصرف الباحث إلى عرض الخطاب الإسلامي الواحد وإلى عرض خطاب النقد من الموقع الفكري الإسلامي نفسه. ويقول بأن حامله على ذلك لم يكن اجتناب التعويض بموقفه النقدي كالقول بأنه متحيّز، مثلاً، ضد المادة الفكرية المعروضة، أو اجتناب التعريض بموقف آخرين بدعوى أنه موقف "براني" أو خارج عن منظومة التفكير الإسلامي، أو علماني، أو إلى ذلك من اتهامات رائجة في ميدان المضاربات الايديولوجية في هذا الوقت..، بل كان حامله الوقوف على آلية التطور، والتجدد الذاتي، والتصحيح، المشتغلة داخل الفكر الإسلامي نفسه، وهو اختيار مرده إلى نمط المقاربة التي انتهجها، وهي تحليل عملية التراكم الفكري الإسلامي: الحديث والعاصر، في مسألة الدولة، وهو تراكم أنجزه مفكرون إسلاميون، ومن الطبيعي الإصغاء والسير في لحظتيه المعرفيتين: لحظة البناء ولحظة النقد