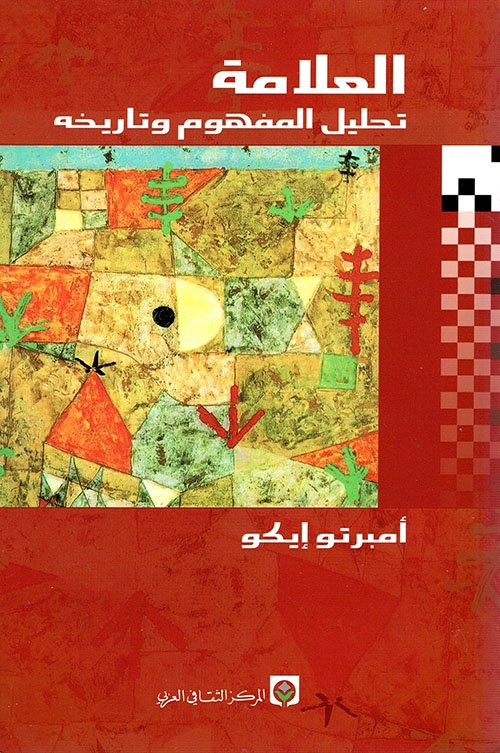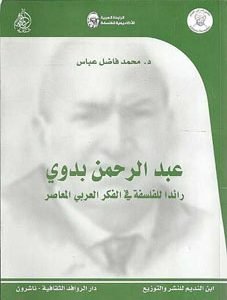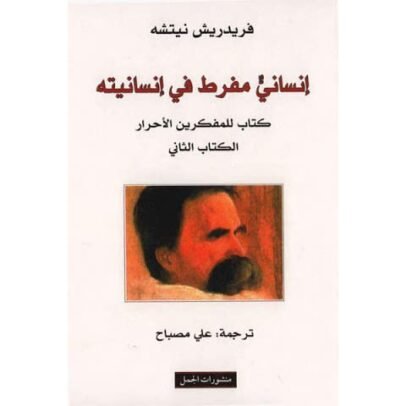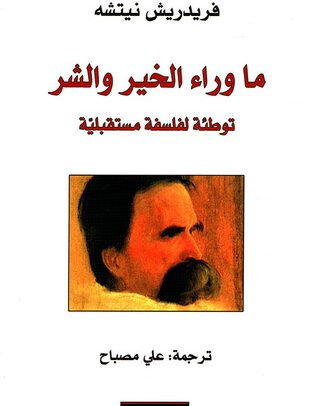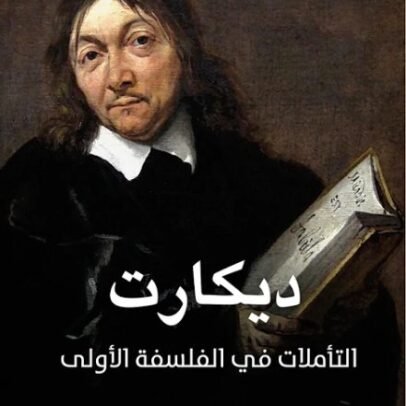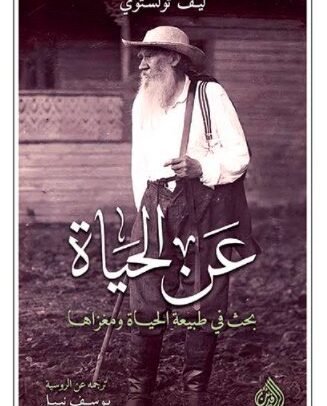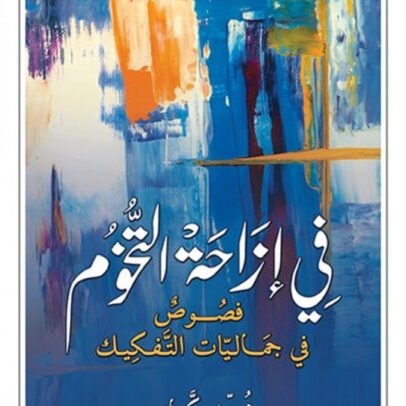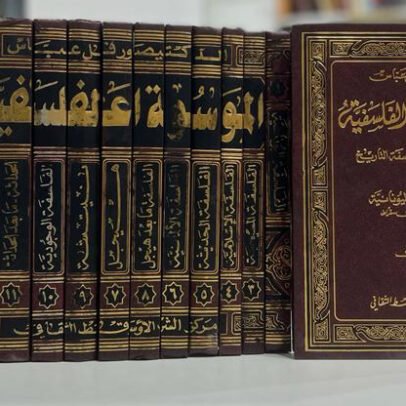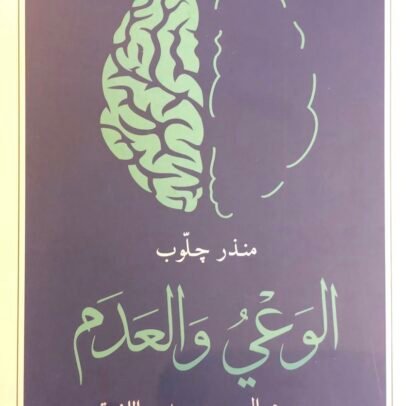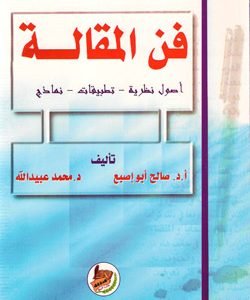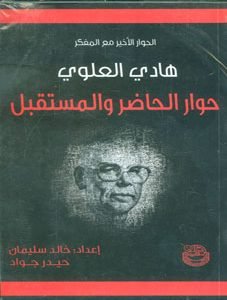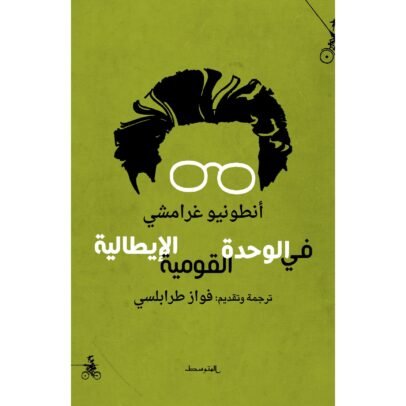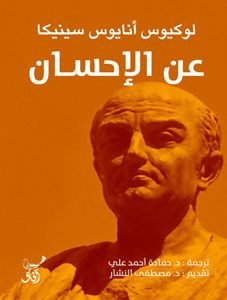د.ك4.5
العلامة تحليل المفهوم وتأريخه أمبرتو إيكو
تك
لهذا الكتاب طابع خاص، فهو لا يقدم لنا تاريخاً خاصاً بالنظريات السيميائية التي عرفتها الأزمنة المعاصرة، ولا يحدثنا عن المردودية التحليلية للمنهج السيميائي -إن كان هناك حقاً منهج سيميائي-، ولا يحدثنا عن الأسماء الكبيرة التي صنعت مجد السيميائيات الحديثة وشهرتها، وإنما يكتفي بتأمل تجربة إنسانية شاملة، يتأمل محاولات الإنسان المضنية من أجل التخلص من براثن طبيعة هوجاء لا ترجم لكي يحتمي بعالم ثقافي (رمزي) يمنحه الدفء والطمأنينة ويوفر له التفاسير الممكنة للظواهر الطبيعية والاجتماعية على حد سواء. وبعبارة أخرى، إنه يبحث في التراث السلوكي والذهني الذي خلفه الإنسان عن الأسس الفلسفية التي تحدد كنه العلامة باعتبارها اللبنة الأساس في سيرورة السميوز (السيرورة المنتجة للدلالات وتداولها). ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار هذا الكتاب تأريخاً لرحلة الإنسان مع الرموز وأشكالها المتعددة، أو هو، نتيجة لهذه الرحلة، تأريخ للرؤى الدينية والفلسفية التي رأت في الطبيعة رموزاً تنوب عن قوى أخرى غير مرئية، أو “هي الصوت الذي يحدثنا الله عبره عن قدرته” كما هو شائع في كل الديانات المساوية المعروفة. ولهذا فإن التاريخ لا يحضر في هذا الكتاب باعتباره تسييجاً لمحطات مرئية ومثبتة في التاريخ العام، بل يمثل أمامنا باعتباره كما زمنياً نقيس من خلاله درجة نمو الأشكال الرمزية وتطورها وتعقيداتها المتصاعدة. يفتتح الكتاب بمدخل يروي فيه أمبيرتو إيكو قصة مواطن إيطالي (السيد سيغما) كان في زيارة إلى باريس، فبدأ يحس فجأة بألم في معدته. فقرر البحث عن طبيب يشخص له المرض ويمده بدواء يسكن آلامه. وفي رحلته هاته، كما يصفها إيكو بأسلوبه الممتع، نكتشف أن الإنسان، وليس السيد سيغما وحده، لا يمكن أن يخطو خطوة واحدة في الحياة دون الاستناد إلى سنن وشفرات تمكنه من فهم وتصنيف ما يحيط به، وتساعده على تحديد موقعه من نفسه ومن الآخرين. فالتسمية والتعرف والتمييز بين الأشياء والكائنات عمليات لا يمكن أن تتم إلا استناداً إلى نسق، صريح أو ضمني، هو الذي يمنح هذه الأحكام والتصنيفية معناها، فـ”العلامة توجد كلما استعمل الإنسان شيئاً ما محل شيء آخر” كما يقول إيكو في هذا الكتاب نفسه. وتلك عي الأسس التي انبنى عليها المجتمع ذاته، فهذا المجتمع “رهين في وجوده بوجود تجارة للعلامات”، فالمجتمع لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا لم يخلق سننه وشفراته الخاصة التي يعتمدها الأفراد المنتمون إليه للتواصل فيما بينهم، وهي التي تسمح لهم بتبادل الدلالات واستهلاكها. استناداً إلى هذا، فإن العلامة هي الشكل الرمزي الأمثل الذي يقوم بدور الوسيط بين الإنسان وعالمه الخارجي، وهي الأداة التي يستعملها في تنظيم تجربته بعيداً عن الإكراهات التي يفرضها الاحتكاك المباشر مع معطيت الطبيعة الخام. بل يمكن القول، استناداً إلى مثال إيكو نفسه، إن العلامة هي الأداة التي من خلالها تأنسن الإنسان وانفلت من ربقة الطبيعة ليلج عالم الثقافة الرحب الذي سيهبه طاقات تعبيرية هائلة. فالإنسان كما يقول إيكو حيوان رمزي (وهو تصور قال به إرنست كاسيرر منذ العشرينيات من القرن الماضي) والرمزية ليست ميزة “لغوية فحسب، بل تشمل ثقافة الإنسان كلها. فالمواقع والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية، والملابس هي أشكال رمزية أودعها الإنسان تجربته لتصبح قابلة للإبلاغ”. إنه كذلك لأن علاقته بالعالم الخارجي ليست علاقة مباشرة. فالإنسان لا يأتي إلى الكون “مغمض العينين” و”خالي الذهن”، إنه يحتك بالطبيعة مسلحاً بالمفاهيم، ومن خلالها فقط يستطيع الإمسام بالكائنات والأشياء والحالات، ليقوم بتصنيفها والحكم عليها. والمفهمة ذاتها هي أول وأرقى أشكال الترميز، أو هي حالة رمزية نستغيض بها عن الوجه المادي للوقائع. ولهذا السبب، فإن الثقافة ذاتها ارتبطت -حسب إيكو- بالفعل الإنساني الهادف إلى اشتقاق ما يؤثر في الطبيعة من خلال الطبيعة ذاتها: اكتشاف الأداة. والأداة هي انفصال الإنسان عن الموضوع، كما أن الرمز هو انفصال عن العالم وتمثل له خارج الإكراهات اللحظية كما يقول جان مولينو. وعلى هذا الأساس، فإن التوسط السيميائي هو الحالة الرمزية المثلى التي مكنت الإنسان من اكتشاف نفسه ووعيها خارج حدود التطابق الوجودي بينه وبين محيطه، وهو ما مكنه من الانفلات من الطبيعة بإيقاع المكرور للولوج إلى الملكوت الحي الذي تقدمه الثقافة احتفاء به وتمييزاً له عن الكائنات الأخرى. ولقد قادت مغامرات الإنسان الأولى مع الرمز ووظائفه إلى تقديم تصورات موغلة في التطرف والمثالية عن تأويل حالة الترميز هاته، فقد أصبحت الطبيعة بأشيائها وكائناتها عند اللاهوتيين وبعض الفلاسفة علامات يحدثنا من خلالها الله عن ملكوت لا نرى منه سوى هذه الصور الرمزية المجسدة في الطبيعة كلها (لقد كانت نظرية أفلاطون أول محاولة في هذا الاتجاه). “فمنذ “طبيعة” بودلير، تلك الغابة من الرموز (…) إلى الفكر الهايدغري، كان الهدف واحداً: ليس الإنسان هو من يصوغ اللغة من أجل السيطرة على الأشياء، بل الأشياء (الطبيعة أو الكائن) هي التي تتبدى من خلال اللغة: إن اللغة هي صوت الكينونة، والحقيقة ليست شيئاً آخر سوى الكشف عن الكينونة من خلال اللغة. وإذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة، فلا فكان للسيميائيات أو نظرية للعلامات”. إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة فنظرة من هذا النوع ستؤدي إلى نفي كلي للزمنية الإنسانية ذاتها ما دام كل شيء معطى بشكل سابق على الممارسة الإنسانية. ذلك أن السنن الثقافية (الأشكال الرمزية) لا تنمو خارج ملكوت الممارسة الإنسانية، فالعلامات هي إفراز للفعل المفرد والجماعي، وليست كما سلوكياً مودعاً في ذاكرة الإنسان خارج تفاعله الحي مع محيطه الطبيعي والإنساني. هذا ما حاولت فصول الكتاب الخمسة أن تجيب عنه: فالكتاب يحاول في مرحلة أولى وصف السيرورة المنتجة للعلامات والمحددة لنموها، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد المعايير التي تصنف وفقها مجمل العلامات الموضوعة للتداول داخل مجتمع ما، ليقدم لنا في مرحلة ثالثة إسهامات البنيوية في تحديد نمط اشتغال الوقائع وطرق إنتاجها لدلالاتها، ليرصد في مرحلة رابعة نمط إنتاج العلامات وطرق تلقيها، لينتهي بفصل يحدد مجمل القضايا الفلسفية التي أثارتها السيميائيات منذ القدم، والفصل عبارة عن سلسلة من التأملات الفلسفية في النشاط السيميائي ذاته باعتباره حالة وعي معرفي رافق الإنسان منذ أ، استشعر ضرورة التحكم في التجربة من خلال الكشف عن وحدتها في التنافر الحسي. إن الأمر يتعلق في جميع الحالات بوصف السيرورة التي من خلالها تدل الكلمات والأشياء والوقائع الاجتماعية وتتحول إلى علامات ضمن أنساق ثقافية بعينها. فالتعرف على مضمون السيرورة والكشف عن حدودها وعناصرها أمران بالغاً الأهمية. فلا يمكن فهم أس سلوك سيميائي إذا لم نحدد في البداية طبيعة السيرورة التي توجد في أساس كل معنى. فالدلالة كما هو معروف لا تكترث للمادة الحاملة لها، فما هو أساس في السيموز ليس الكم الدلالي المدرج للتداول داخل الممارسة الإنسانية، بل العلاقات الممكنة بين عناصر كل واقعة. وبناء عليه فالدلالة ليست كلا مكتفياً بذاته وليست معطى سابقاً في الوجود على الممارسة الإنسانية، إن الدلالة هي سيرورة في المقام الأول، فالعناصر دالة لوجود علاقات فيما بينها، وهي مستويات في المقام الثاني لأنها محكومة في وجودها بالسياقات التي تخلقها هذه الممارسة.